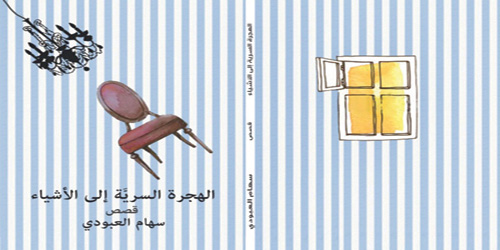شاهد من أهلها / د. دوش بنت فلاح الدوسري
شغف المعرفة.. هو الحل

2018/01/04
أصيب الأديب المصري المعروف مصطفى صادق الرافعي بالصمم في صباه، فترك مقاعد الدراسة، لكن شغف المعرفة جعله يعكف على مكتبة أبيه، ليقرأ ويقرأ، حتى كان الرافعي هذا الاسم الكبير.
ويذكر برتراند راسل الفيلسوف وعالم الرياضيات البريطاني، أنه أراد الانتحار في مراهقته، غير أنه أحجم عن المحاولة، حين تذكَر أن ثمة ما يريد إكمال بحثه في شغفه المعرفي (الرياضيات).
لقد تحوَلت حياة الرافعي تحوُلاً هائلاً، حين عكف تلك الساعات الطوال في القراءة لتنمو شخصيته الإنسانية والعلمية، وأنقذ الشغف حياة راسل، حين تذكر أن لديه اهتماماً معرفياً في هذه الحياة.
السرُ يكمن في وجود هذا الشغف الذي يدل في اللغة على درجة عالية من درجات الحب، حين يتعمق في أقصى نقطة في القلب.
هذا الحب العميق للمعرفة هو الذي سيصنع المتعة والصبر والمثابرة والاستمرارية، ويعين صاحبها على التوثب والنهوض في كل مرة يقع فيها، وسوف يغذِيه بالعمق وسعة الأفق. فحين يؤمن بوجود رسالة في حياته، سيمنحه هذا قيمة ذاتية، ويشحنه بالقوة والطاقة والإيجابية، ويساعده على النهوض بنفسه ومن ثم بمجتمعه.
ولو فكرنا في إشكالات كثيرة في حياتنا، لتأكدنا أن حلها يكمن في وجود شغف معرفي.... وجود الفراغ في الإجازات الطويلة لدى الشباب والإشكالات التي تنشأ عنها، سببها الأساسي عدم وجود شغف معرفي لدى الشاب يشغله ويدفعه للانكفاء عليه، بوصفه رسالة في حياته.
الانشغال بتفاهات الحياة ومتابعة التافهين عند المراهقين، سببه الأساسي عدم وجود شغف معرفي يدفع المراهق للتفكير بعمق أمام هذه الاهتمامات، فهذا الفراغ المعرفي في عقله، يجعله مخزناً فارغاً.
كره الطلبة للمدرسة، وتهربهم منها، وولعهم بالغياب، من أسبابه انعدام الشغف المعرفي.
الضعف الذي نراه في بعض رسائل الدراسات العليا، والتكوين العلمي والشخصي الضعيف لبعض طلبة الدراسات العليا سببه الأساسي عدم وجود شغف معرفي يبني الشخصية العلمية، ويبني روح المتعلم.
كل هذا يستدعي من المربين من أساتذة في التعليم العام والتعليم العالي، ومن الآباء والأمهات، أن يتلمسوا شغف تلاميذهم وأبنائهم من البدايات، وأن يساعدوهم على اكتشافه وتنميته، بل بنائه من جديد إن لم يكن موجوداً.
ومن المهم أن تتطور وسائل وأساليب التدريس، بحيث تتناسب مع عقليات أبناء هذا الجيل، وتساعدهم على حب المعرفة والتعلق بها.
وعلى الإنسان نفسه، بمجرد تجاوزه مرحلة الطفولة، تعهد ذاته بالقراءة والتسلح بالمعرفة، والبحث عن اهتماماته وميوله وتنميتها. على الإنسان ألا ينتظر من يأخذ بيده، فكل العظماء الذين قرأنا عنهم، انطلقت حياتهم بالتأمل الذاتي العميق.
إننا نعيش حياة واحدة.. وبئس الحياة التي سنخرج منها فارغين بدون أثر، وبدون رسالة، وبدون رؤية..
ولن يتحقق لنا هذا إلا حين تتحول المعرفة إلى شغف، نبحث عنها بحب ومتعة، ونعمل على ضوئها لأنفسنا ومجتمعاتنا بحب ومتعة.
د. دوش بنت فلاح الدوسري
أستاذ الأدب والنقد المشارك - جامعة الأميرة نورة